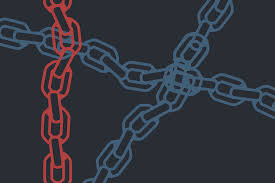معضلة بناء الدولة الوطنية الحديثة في سورية والمشرق العربي؟/ مهران الشامي

لماذا نجحت معظم مجتمعات العالم في بناء دولها الوطنية الحديثة، بينما فشلنا نحن العرب، وخصوصًا في مشرقنا العربي؟ أين تكمن العلّة وراء ذلك، ما المعوقات التي حالت دون تمكننا من العبور إلى بناء دولنا المنشودة؟ هل يتعلق الأمر بدور الآخر، الخارج «المتآمر» علينا؟ أم أنّ الذات الجمعية وبناها التاريخية المُعطاة لم تكن تسمح لها بأن تفعل أكثر مما فعلت، أو لم يكن بالإمكان أبدع مما كان، كما يقال؟!
وإذ أشير إلى دول المشرق العربي، فلأنّني أحسب أنّ أوضاع هذه البلدان متشابهة من حيث النشأة، ومترابطة إلى حد كبير فيما بينها بفعل العوامل، الداخلية والخارجية، التي ما زالت تؤثر في تكوينها وتطورها.
الدور الخارجي.. حيثيات تاريخية
من المعروف للجميع أنّ نشوء وتكوّن كيانات المشرق العربي لم يأتِ نتاجًا لمستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لشعوبها، ولم يأتِ كذلك حصيلة لصراعات داخلية حتّمت عليها في نهاية المطاف التوافق على عقد اجتماعي جديد، يضمن العيش المشترك بين كل أبنائها ومكوناتها، على غرار ما حصل في المجتمعات الغربية بعد حرب الثلاثين عامًا الدينية الطاحنة التي شهدتها.
فالشريف حسين كان يعوّل خلال الحرب العالمية الأولى على تحالفه مع بريطانيا، لإقامة كيان عربي مستقل يمتد من مكة إلى كامل أراضي بلاد الشام. ولكنّ رهانه لم يُؤتِ ثماره المرجوة؛ لا بالنسبة إليه، ولا بالنسبة إلى القوميين العرب الثائرين آنئذٍ ضد تركيا. وبدلًا من قيام مملكة عربية مستقلة تحت قيادته، جرى اقتسام الأقاليم العربية في الإمبراطورية العثمانية السابقة بين الإنكليز والفرنسيين.
وقد تمّ ذلك وفق تفاهمات واتفاقات معروفة: «سايكس بيكو» 1916، «سيفر» و«سان ريمو» 1920، و«لوزان» 1923. إضافة إلى وعد بلفور (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917)، الذي تحوّل بعد مؤتمر «سان ريمو» إلى «وثيقة قانونية»، عبر إدراجه ضمن قراراته التي اعتمدتها «عصبة الأمم» لاحقًا.
وخلال زيارته إلى باريس (1918) للمشاركة في “مؤتمر الصلح”، بعد انتصار الحلفاء، طالب الأمير فيصل بأن يصبح ملكًا على سورية، استنادًا إلى مراسلات والده مع مكماهون، وخدمات العرب للحلفاء خلال الحرب، فضلًا عن حكومته الفعلية التي كان أسّسها في دمشق بدعم بريطاني، ولكنه اكتشف أنّ لندن كانت وعدت بتقديم سورية إلى كلٍّ من والده، كممثل للعرب، وإلى فرنسا في الوقت ذاته.
وطبعًا، حرصت بريطانيا على إرضاء حليفتها فرنسا أولًا. وفي نيسان/ أبريل 1920، تمّت تسوية قسمة غنائم الحرب في مؤتمر سان ريمو، فجرت مكافأة بريطانيا وفرنسا بأشكال من الانتداب متفقة بدقة مع مصالحهما في المنطقة؛ فحصلت الأولى على فلسطين والعراق، وفازت الثانية بسورية ولبنان.
ولكن إذا كانت بريطانيا وفرنسا قد قضتا على نظام السلطنة العثمانية في المنطقة، ورسمتا حدودًا وأوجدتا بلدانًا وعينتا حُكامًا، وحاولتا أن تبنيّ أنظمة على شاكلة النظام السياسي للدول الغربية؛ فإنّ كثيرًا من القوى المحلية واجهت هذه الترتيبات بالرفض والمقاومة واعتبرتها غير شرعية. يضاف إلى ذلك المشكلات التي خلفتها ولا زالت معلّقة حتى الآن؛ مثل المصير السياسي للفلسطينيين والأكراد وعدد من الأقليات الأثنية الأخرى.
ويلاحظ ديفيد فرومكين في كتابه (سلام ما بعده سلام) أن الاحتلال الأوروبي لبلدان الشرق الأوسط، والتغيرات التي اقترح إدخالها إلى المنطقة، كانت بحاجة إلى أجيال لتمريرها وترسيخها، في حين أن أوروبا الخارجة من الحرب لم تكن قادرة على القيام بهذه المهمة، ولم تكن أوضاعها تسمح لها بذلك، لا من حيث الموارد اللازمة، ولا من حيث الحماسة.
وهكذا، وبعد نحو قرن على تسوية عام 1922 في المنطقة، كما يقول فرومكين، فإنّ الخلافات في الشرق الأوسط ما زالت عميقة وتشمل الهوية السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات، إضافة إلى شرعية الكيانات الناشئة ذاتها، وكذلك شرعية الأنظمة السياسية القائمة فيها، التي تنظر إليها كثيرٌ من القوى والحركات الاجتماعية والسياسية، بوصفها تعبيرًا عن عقيدة غربية أو “غزوًا ثقافيًا غربيًا”، وترى أن تطبيق الشريعة التي تتحكم في مختلف جوانب الحياة (ومن ضمنها الحوكمة والسياسة)، أمرٌ مفروغ منه!
ويضيف فرومكين أنّ المسؤولين الغربيين الذين شاركوا في اقتسام المنطقة وطلب الانتداب عليها “ظنوا أن المعارضة الإسلامية للعصرنة كانت في طريقها إلى التلاشي، ولم يروا أهمية المذهب الوهابي في السعودية، ودور الدين في أفغانستان، واستمرار حيوية الإخوان المسلمين في مصر وسورية، والثورة الخمينية في إيران… الخ”. ويزيد أنّ من أسباب استمرار المقاومة المحلية لتسوية عام 1922، أنه “ليس في المنطقة إيمان يشارك فيه الجميع بأن الكيانات السياسية القائمة والحكام القائمون عليها، لها ولهم حق الاعتراف بهم كبلدان وكحكام”(1).
يجدر بالذكر هنا أنّ حكومة لندن كانت عقدت اتفاقات مع أطراف متعددة ومتضاربة المصالح، أحدها كان مع ابن سعود (العدو اللدود للشريف حسين)، حيث اعترفت به حاكمًا مستقلًا، في كل من نجد والإحساء وباقي المناطق التي كان يسيطر عليها، في مقابل وعده بأن يبقى محايدًا في الحرب.
وتكشف وثائق سرية للحكومة البريطانية (1919) أنّ الأرقام المتصلة بأعداد الجنود الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الحسين خلال الحرب مبالغٌ فيها كثيرًا، وأن العدد الحقيقي لهؤلاء لم يكن يتجاوز بضعة آلاف فقط.
وفي تقرير عن “ثورة الحجاز” عام 1918، أعدّه ما يسمى “المكتب العربي” التابع للحكومة البريطانية، ورَدَ أنّ “90 % من جنود الشريف حسين ليسوا أكثر من رجال سلب ونهب”. وأنّ “العرب لم يثوروا على الأتراك إلا بعد وصول القوات البريطانية”. ويرِدُ فيه كذلك أن الحسين “غارق في أحلام جامحة عن الفتوحات، ولكنّ سحبَ التأييد البريطاني سيتركه تحت رحمة ابن سعود والموجة الوهابية الصاعدة”.
ولكنّ مسؤولين بريطانيين آخرين يخالفون هذا الرأي، ومنهم مارك سايكس نفسه الذي رأى أنّ “فيصل وأشقاءه أسهموا إسهامًا كبيرًا في المجهود الحربي، وأن ثورة الحجاز شاغلت 38 ألف جندي عثماني”(2).
ويرى فرومكين أن مدى إسهام فيصل في نجاحات الحلفاء سؤال لم يجد جوابًا عليه آنذاك، ولا يزال بلا جواب حتى الآن. ولكنه يثير أسئلة أخرى من قبيل: “هل دعمت بريطانيا الحسين وفيصل ضد الزعامة السورية المنبثقة من أهل البلد ذاته، والتي قد يكون لها شعبية أكبر بكثير بين أبناء البلد؟”، وهل كانت بريطانيا تؤيد فيصل ضد أبيه الحسين، وقد شكا الأخير من أنهم “جعلوا ولده ينقلب عليه، وبأنه أصبح خائنا له”!
وتكشف بعض المراسلات التي جرت بين المسؤولين البريطانيين أنّ “السوريين لم يكونوا راضين تمامًا عن سيطرة المشيخة المكية (الرجعية) عليهم”. وأن فيصل كفرد كان مقبولًا لديهم، ولكن ليس كممثل لوالده(3).
مشروع الحركة الصهيونية
لم يكن اهتمام القيادة البريطانية ينصبّ آنذاك على تأمين قيادات مطواعة في البلدان التي ستبسط عليها انتدابها فحسب، بل على أن تكون هذه القيادات على علاقة حسنة مع الحركة الصهيونية أيضًا، وقد مارست عليها ضغوطًا مباشرة في سبيل ذلك!
وعلى سبيل المثال، سعت هذه القيادة (ممثلة بقيادة الجنرال اللنبي العسكرية في المنطقة) إلى ترتيب لقاء بين الأمير فيصل وحاييم وايزمان، زعيم الحركة الصهيونية المعروف، رحّب الأول في ختامه بإمكان قيام «صداقة بين اليهود والعرب». ونقل الكولونيل جويس، كبير مستشاري الأمير الذي حضر اللقاء، بأن “فيصل رحّب بإمكانية التعاون العربي اليهودي، معتبرًا أنّ هذا التعاون جوهري لتحقيق الطموحات العربية”. وحسب قوله فإن “فيصل كان سيقبل بفلسطين يهودية، إذا كان ذلك سيقنع الحلفاء بتأييد مطالبه بسورية”!
وأضاف جويس أن هذا الاجتماع مهّد الطريق للتأييد العلني للصهيونية الذي قدّمه فيصل في مؤتمر الصلح. كلّ ذلك، في وقت كان اهتمام الأخير ينصب على تأمين ولايته على سورية، ولا يكترث، في قليل أو كثير، لما يجري في فلسطين(4).
ومن النافل التذكير، أنّ بريطانيا انتزعت من فيصل اعترافه وتأييده للمشروع الصهيوني في فلسطين، على الرغم من عدم مساعدته في حكم سورية، قبل أن تعوّضه في ما بعد بحكم العراق، الذي يُنسب إليه قوله عنه بعد أكثر من عشر سنوات من حكمه (1932): “لم يتكون الشعب العراقي بعد، ما لدينا هو حشود من البشر يفتقرون لأي وعي وطني أو شعور بالوحدة، منغمسين في الخرافات الدينية والتقاليد، يتقبلون الشر ويميلون نحو الفوضى، وهم مستعدون دائمًا للوقوف ضد أي حكومة أيًا كانت”. وذلك في إقرار واضح بأن الدولة في العراق ليست إفرازًا طبيعيًا لشعب أو لأمة، وإنما هي شيء مستورد من الخارج، على خلفية تقاسم المصالح وتوزيع الكعكة بين المنتصرين(5).
أما في شرق الأردن، فإنّ الميل البريطاني إلى تثبيت الكيان الناشئ ترافق مع إلزام الأمير عبد الله بالخضوع الكامل للمشيئة البريطانية، سياسيًا وماليًا وعسكريًا. وكانت لندن وجّهت إنذارًا مكتوبًا إليه، وهو في طريق عودته من الحج (آب/ أغسطس 1924)، تهدّده فيه بـ “إعادة النظر في وضع شرق الأردن كلّه”، إذا لم يستجب للبنود الواضحة والصريحة فيه، وقد أذعن الأمير طبعًا(6).
وكانت أغلب سياسات عبد الله تتماهى أصلًا مع السياسة البريطانية؛ فقد تجنّب انتقاد وعد بلفور وما تضمنه من التزام بريطاني بالمساعدة على قيام “وطن قومي لليهود”. وبدورها، فقد كانت الحركة الصهيونية مهتمة بتطوير صلاتها مع الأمير، فكانت تؤمن الأطباء له ولأفراد أسرته. وكان بعض مسؤولي المنظمات الصهيونية في فلسطين يقومون بزيارات منتظمة له. وفي عقد الثلاثينات ناقشوا معه العديد من المشاريع المشتركة في عمّان، وعلى ذلك، فقد اتهم في فلسطين بأنه “باع نفسه للصهاينة”(7).
وترى ويلسن في كتابها حول سيرة عبد الله أنّ حرصه على إنجاز صفقاته مع الصهاينة مردّه أنه لم يكن حينها يفكر بفلسطين، بل بصراع أبيه مع آل سعود في الجزيرة العربية. وربما شعر بأن حصوله على المال اللازم لدعم الاضطرابات القبلية في الحجاز وعسير أكثر أهمية من سمعته في فلسطين.
وعلى العموم، فإنّ بروز الحركة الصهيونية ومشروعها لبناء دولة يهودية استتبع صراعًا مفتوحًا مع العرب، شكّل في جانب منه عائقًا موضوعيًا أمام تنمية ونهوض مجتمعاتنا العربية (وخصوصًا المشرقية منها) وبناء دولها، وفي جانب آخر، مشجبًا (فريدًا) عُلّقت عليه عناصر الإخفاق والهزائم التي تسبّبت فيها الأنظمة الاستبدادية التي حكمت تلك المجتمعات.
تشكيل الكيان الأردني
يُعدّ تشكل الكيان الأردني الذي احتفل بمئويته قبل أيام نموذجًا ساطعًا عن الدور الخارجي الاستعماري في تشكل الكيانات العربية؛ فشرق الأردن لم يكن مدرجًا ككيان مستقل ضمن الاتفاقات المذكورة أعلاه، إذ كان يُعدّ جزءًا من سورية الطبيعية (بلاد الشام) التي تضم، إضافة إليه، كلًّا من سورية ولبنان وفلسطين وجزءًا من العراق. ولكن بريطانيا (الإمبراطورية العظمى آنذاك) شرعت بالتفكير بإعطائه وجودًا منفصلًا، تلبية لاحتياجاتها الاستراتيجية والسياسية.
وكانت حكومة صاحب الجلالة قرّرت أيضًا أن يتمّ تنصيب الأمير فيصل ملكًا على العراق. وهكذا، فقد بقي شقيقه عبد الله من دون منصب، واعتبرت أن ذلك “مشكلة تستوجب حلًا”، وتقاطعت هذه مع مشكلة أخرى هي قضية “مستقبل شرق الأردن”! ولحلّ المشكلتين معًا، التقى ونستون تشرشل (وزير المستعمرات البريطاني المعيّن حديثا)، مع عبد الله في القدس (26/3/1921) على مدى ثلاثة أيام، واتفق معه في نهايتها على إقامة نوع من الإدارة العربية في شرق الأردن خاضعة للإشراف البريطاني. ويقال إنه “أغوى” الأمير بالبقاء في عمّان، عبر تقديم وعد ضبابي بأن تساعده بريطانيا في الوصول إلى حكم دمشق، وذلك إذا ساعد في لجم النشاطات المعادية لبريطانيا والصهيونية، وكذلك لفرنسا في الشمال.
وهكذا كان اتفاق تشرشل مع الأمير عبد الله نقطةَ الإقلاع في إنشاء “شرق الأردن”، على الرغم من أنه لم يكن يضمّ آنذاك سوى أقلّ من 230 ألف نسمة فقط، أغلبهم من البدو والمزارعين. ولا تتوفر فيه أية مقومات ثقافية أو عرقية أو اقتصادية أو جغرافية ليكون كيانًا مستقلًا بذاته، لكونه مجرد معبر صحراوي لا يحتوي على مراكز حضرية (مدن)، ولا موارد طبيعية، ومن دون أي أهمية اقتصادية أو تجارية تذكر!
ولم يكن الاتفاق وانفصال الكيان في البداية مطلقًا، بل قُيّد بالتجريب؛ إذ كان لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وبعد انقضاء الفترة الأولى، بدأ رأي تشرشل وحكومة لندن يستقرّ لصالح بقاء الاتفاق ساريًا إلى أن يتمّ حسم وضع فلسطين والانتدابات الأخرى بصورة نهائية.
ومن المعروف في هذا الصدد، أنّ بريطانيا ظلّت تدعم الكيان الجديد على مدى عقود، ماليًا وعسكريًا ودبلوماسيًا، قبل أن تضطلع الولايات المتحدة لاحقًا بهذه المهمة. ومن هنا، فقد أطلق عليه كثيرون لقب “الكيان الوظيفي”! ولكنّ وضع الكيان تعزّز أكثر بعد الانسحاب البريطاني من فلسطين، إذ سمحت لندن للفيلق الأردني، في حرب الـ 48، بالاستيلاء على المناطق الفلسطينية التي وُصِفت بـ “العربية”، بموجب قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، منطلقة من أنّ تسليم هذه المناطق لحليف مضمون أفضل من قيام كيان فلسطيني مستقل فيها، فيما كان عبد الله أيّد مسبقًا قرار التقسيم.
وبعد ضمّ الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية عام 1949، وتوسّع شرق الأردن وتحوله إلى مملكة، اهتدى هذا الكيان ومؤسّسوه إلى علة وجود جديدة له، تضاف إلى الأسباب الأولى لإنشائه. ولقد عارضت جميع الدول العربية خطوة ضمّ الضفة الغربية (عادت وأعلنت المملكة فك ارتباطها بها 31 تموز/ يوليو 1988)، لكنها عجزت عن فعل أيّ شيء؛ لا ضد إسرائيل، ولا على صعيد تمكين الفلسطينيين من إيجاد بديل للحكم الهاشمي.
سيطرة الأحزاب الشمولية
وكان من أهمّ أسباب إعاقة فرص تشكل دول وطنية حديثة في المشرق العربي، تنامي التيارات والقوى السياسية (القومية والإسلامية والشيوعية) ذات المشاريع والتوجهات العابرة للحدود الوطنية، والتي لم تبدِ أدنى اهتمام؛ لا على مستوى الفكر ولا على مستوى الممارسة السياسية، لبلورة رؤية فكرية ودستورية ناضجة لقضية بناء الدولة، وصوغ عقد اجتماعي يتوافق عليه أبناء المنطقة في مختلف بلدانها.
وقد تمثلت الطامة الكبرى في سيطرة أحزاب قومية على السلطة (مصر، سورية والعراق وغيرها)، وتكريس سلطات استبدادية مطلقة، احتلت الفضاء العام، وألغت الحريات والحياة السياسية، وصادرت أيّ وجود لهيئات وتكوينات مدنية أو نقابية مستقلة (وهي إحدى الدعائم الرئيسة لبناء الدولة الحديثة)، فضلًا عن مشاريعها الخُلّبية المتهافتة لقيام “وحدات أو اتحادات عربية”، أخفقت جميعها!
وترتب على ذلك، في المحصلة، تصحير شبه كامل للحياة الفكرية والسياسية في تلك الدول، ومن ضمن ذلك قصور واضمحلال الوعي القانوني والدستوري، حيث بتنا نفتقر، ما خلا بعض الحالات القليلة والنادرة، إلى وجود أعلام في الفكر السياسي والدستوري، وكذلك إلى الخبرة اللازمة في هذه المواضيع والقضايا الشائكة والمعقدة.
وعلى سبيل المقارنة فقط، فإنّ الآباء المؤسّسين للدستور الأميركي: (ألكسندر هاملتون وجيمس ماديسون وجان جي) كانوا ناقشوا مختلف الجوانب المتصلة بصياغة دستور فيدرالي للولايات المتحدة، “يُخفّف من آلام وشرور أي نظام سياسي”، على حدّ تعبير هاملتون. وقد وضع هؤلاء الرسائل الخاصة بذلك، (85 رسالة)، نُشرت في الصحف المحلية لمدينة نيويورك ما بين عامي 1787 و1788، قبل أن تُطبع في كتاب.
وفي هذه الرسائل، يشرح هؤلاء فضائل النظام الفيدرالي من الجوانب كافة؛ الاقتصادية والعسكرية والسياسية والقانونية، مع تأمّلهم وتمحيصهم في التجارب المماثلة، سواء في التاريخ القديم (الجمهوريات الإغريقية) أم في التجارب الأوروبية الأقرب إليهم، آخذين بعين الاعتبار كذلك أنّ علم السياسة تطور كثيرًا، وأدخل تحسينات عظيمة على نفسه (كان هذا قبل أكثر من قرنين من الزمن!)؛ من قبيل التوزيع المنتظم للسلطات، وجعلها في دوائر منفصلة ومتمايزة، وإدخال الكوابح التشريعية وتشكيل محاكم مستقلة.. الخ(8).
وقد يعزو البعض نجاح التجربة الأميركية إلى ما فعله جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة (1789 ـ 1797)، و”الأول في الحرب، والأول في السلام، والأول في قلوب مواطنيه”، كما كان يوصف، وذلك حين رفض التجديد لنفسه بعد ولايتيه الرئاسيتين، وأصرّ على التنحي وترك المنصب، بادئًا بنفسه بتكريس هذا السلوك السياسي، انطلاقًا من رغبته في “بناء دولة قانون لا دولة أشخاص”، ورؤيته لضرورة بناء “أمة عظيمة وقوية على أسس جمهورية واتحادية راسخة”.
وفي المقابل، فقد انتشرت ظاهرة عبادة الفرد وتقديس القائد، في كثير من الدول التي توافرت فيها بنى اجتماعية وسياسية وثقافية حاضنة لهذه الظاهرة؛ (روسيا، الصين، العديد من بلدان العالم الثالث والعالم العربي…). وما بين الوعي المدني والمؤسساتي القاصر، وغلبة الانتماءات والعصبيات ما دون الوطنية، ونزوع واستعداد بعض القيادات للانخراط في الظاهرة، فإنّ التربة الخصبة لولادتها سرعان ما تصبح جاهزة، ولا ينقصها سوى الآليات والوسائل اللازمة لذلك؛ تنظيميًا وسياسيًا وبوليسيًا، لنحصد في النتيجة تعميم القمع والخوف وتدجين الشعوب، وتكريس الطاعة العمياء للقائد فحسب!
فشل مشروع النهضة وتراجع الحركة التنويرية
ومن أسباب تعثّر بناء الدولة الحديثة في معظم بلداننا العربية، فشلُ مشروع النهضة والحداثة الذي بدأ أواخر القرن التاسع عشر، وتراجع الحركة التنويرية والعقلانية التي رافقته، علمًا أنّ نشوء الدولة الحديثة ترافق مع انفصال ما هو سياسي عمّا هو ديني، وتحقّق نوع من الاستقلال النسبي للأنساق والسلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية عن الدين، وعن بعضها البعض في الوقت عينه.
وقد تجسّدت فكرة الدولة الوطنية في أوروبا، بدايةً، وفق المنظومة التي أرستها معاهدة ويستفاليا التي أنهت الحروب الدينية الدموية التي دامت نحو ثلاثة عقود ما بين عامي 1618 و1648. وارتكزت على مبدأ عدم التدخل، والاعتراف بسيادة الممالك والإمارات على الأراضي الخاضعة لها، وإنهاء مبدأ الاضطهاد الديني.
لم تتكفّل «ويستفاليا»، وحدها، بإنجاز ما حققته الشعوب الأوروبية على صعيد بناء دولها الوطنية المنشودة، بل احتاج الأمر إلى وقت طويل، وجاء في المحصلة كصيرورة تطوّر داخلية معقّدة ومتعرّجة ومتفاوتة المستوى بين الجهات الأوروبية، واستمرّ ذلك حتى قيام الثورة الفرنسية عام 1789، ولم ينقطع بعدها كذلك، لكنّ السلام النسبي الذي خلّفته “ويستفاليا” أتاح الفرصة أمام أوروبا لتحقيق تطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وكذلك الفكري والعلمي والتكنولوجي، إلى جانب ما وفرته له مستعمراتها، “في ما وراء البحار”، من إمكانية مراكمة الثروات وتحقيق التراكم الرأسمالي البدئي.
وترافق ذلك كله، مع تجريد الكنيسة من مصادر قوتها وهيمنتها الاقتصادية والاجتماعية، والحدّ من نفوذها السياسي ونفوذ طبقة رجال الدين (الأكليروس)، ومن ثم البدء في الفصل التدريجي بين الكنيسة والسياسة، وشيوع التنظيم المدني العلماني للدولة والأنظمة السياسية المعمول بها، إضافة إلى تطور نُظم التعليم وانتشار الجامعات الحديثة، بعيدًا من القيود الدينية والسلطوية التي كانت مفروضة على حرية التفكير والإبداع والبحث العلمي.
هذا يقودنا إلى الإقرار بأنّ الغَلبة -على الرغم من كل الجهود التي بذلها التنويريون العرب منذ عصر النهضة حتى الآن في سبيل تعزيز أسس الفلسفة السياسية العقلانية الحديثة فلسفة حقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية- ما زالت للفكر اللاهوتي التكفيري الظلامي، وما زالت أفكار وفتاوى ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ورشيد رضا وحسن البنا وغيرهم أقوى بما لا يقاس مما طرحه النهضويون والعقلانيون العرب، فضلًا عمّن سبقهم من مفكرين تنويرين وعقلانيين غربيين أمثال؛ ديكارت وسبينوزا وفولتير وروسو وكانط وغيرهم كثيرون.
ولعلّ نجاح الثورة الفرنسية، في تشكيل قطيعة فعلية مع الماضي، يُعزى في جانب رئيسي منه إلى نجاح فلاسفة التنوير قبلها في تفكيك اللاهوت المسيحي التكفيري وتمهيد الطريق لها، وهذا ما لم يحصل عندنا بَعدُ، مع الأسف الشديد.
وينقل هاشم صالح، عن المؤرخ الفرنسي دانييل مورنيه، قوله: “لولا الثورة الفكرية التي أحدثها فلاسفة التنوير في العقول، لما كانت الثورة الفرنسية”، مضيفًا أنّ التنوير هو الذي فكك مشروعية الكنيسة الكاثوليكية وكل الأفكار الطائفية المتعصّبة التي كانت تبثها في المجتمع، ولولا هذا التفكيك لما استطاعت الثورة الفرنسية أن تطيح النظام الملكي الاستبدادي المطلق، الذي كان يستمدّ مشروعيته من هذه الكنيسة بالذات، فهي التي كانت تخلع عليه المشروعية الإلهية، وتُقنع جماهير الفرنسيين بتقديم الطاعة له، والخضوع لمشيئته على الرغم من كل تعسّفه واستبداده”(9).
اشتداد الصعوبات والمعوقات
ثمة انسدادٌ واستعصاء وصلت إليه مجتمعاتنا، على صعيد بناء دولها الوطنية المنشودة. فما العمل في مثل هذه الحال؟ هل ثمة مخرج مما نحن فيه سوى الانخراط الجدّي في مشروع استعادة الدولة، وإعادة بناء وصياغة الكيان السياسي القادر على استيعاب واحتواء التناقضات السياسية والاثنية والطائفية والدينية، على الرغم من أنّ تلك التناقضات قد تنامت ووصلت إلى ذروتها في السنوات الماضية، وخصوصًا بعد الحرب الوحشية المدمّرة، وما أدّت إليه من تمزيق وتهتيك للنسيج الاجتماعي السوري، ومن استقطابات سياسية وطائفية واثنية حادة، متراكبة مع تدخلات واحتلالات إقليمية ودولية، لن يكون تجاوزها بالأمر الهيّن أبدًا؟
ولعلّ أسوأ الاحتمالات التي قد يخلص إليها الباحث هو أن تكون الحروب والصراعات المستمرة، على هذا النحو أو ذاك، (في سورية وغيرها من الدول العربية)، شكلًا من أشكال تكرار الحروب الدينية والاثنية التي شهدتها أوروبا، إبان تطورها البورجوازي في القرنين السادس والسابع عشر، قبل أن تذهب إلى بناء دولها الحديثة؛ أي على مجتمعاتنا أن تعيد الكرّة والصيرورة ذاتها التي مرّت بها الشعوب الأوروبية، قبل أن تصحو وتتفق أخيرًا على أن هذا النهج والمنوال المدمّر لا يجدي نفعًا، ولا بدّ من الاهتداء إلى ضرورة بناء دول تكون لكل مكوناتها ومواطنيها، من دون أي تفريق.. دول تُنهي الاستبداد السياسي والاضطهاد الديني، وتضمن حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، وفي صدارتها الحق في الحياة، وعدم التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة، كخطوة أولى نحو نزع فتيل الحروب والصراعات الأهلية المحتدمة، هنا أو هناك.
وفي الطريق إلى ذلك، قد يحتاج الأمر إلى قيام صلح إقليمي شبيه بـ “ويستفاليا”، ولكن إذا قيّض لهذا الصلح أن يتحقق، فهو لن يحصل -على الأرجح- إلا باتفاق القوى الإقليمية والدولية عليه، أي على نحو يتعارض مع إمكانية تجريم تدخل هذه القوى في شؤون الساحات والدول المعنية، كما كان الحال في ويستفاليا!
__________
المراجع:
1ـ دافيد فرومكين «سلام ما بعده سلام ـ ولادة الشرق الأوسط 1914 ـ 1922» نسخة الكترونية ص 633، أسعد كامل إلياس، إصدار: رياض الريس للكتب والنشر.
2ـ المصدر السابق، ص 365.
3ـ المصدر السابق، ص 368.
4ـ المصدر السابق، ص 361.
5ـ وردت في مقال مارتن كريمر «خلافة مفاجئة، هل هناك أهمية لوفاة الملك؟»: «معهد واشنطن»، 11/4/2019.
6ـ ماري ولْسُن، عبد الله وشرق الأردن بين بريطانيا والحركة الصهيونية، ص 144، والكتاب صادر عن دار «قدمس» للنشر والتوزيع، ترجمة فضل الجراح، بيروت 2000.
7ـ المصدر السابق، ص 176.
8ـ جمعت هذه الرسائل في كتاب «الأوراق الفيدرالية»، وقد ترجم إلى العربية من قبل دار الفارس للنشر والتوزيع سنة 1996، عمان، الأردن. وقام بالترجمة عمران أبو حجلة وراجعها د. أحمد مظهر.
9ـ هاشم صالح، «الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ»، دار الساقي 2013، ص 185ـ 186.
مركز حرمون